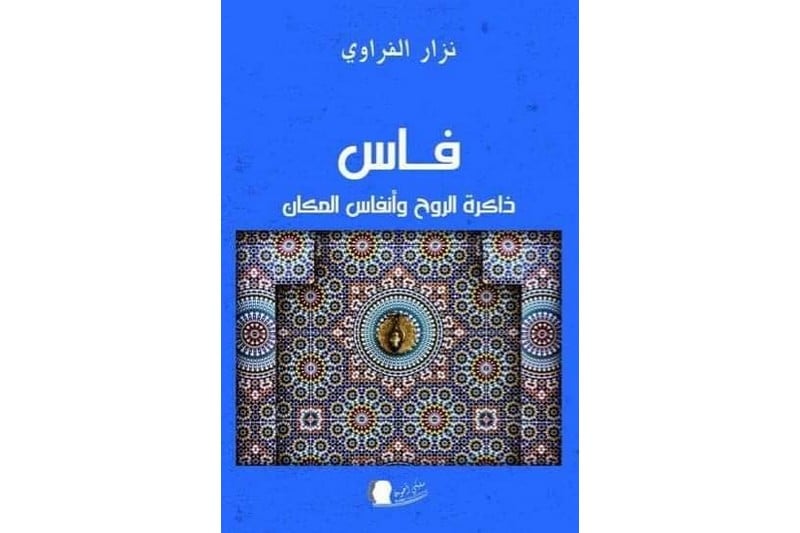[ad_1]
عبر سفر روحي وفكري برهانات جمالية تجديدية، يحلق بنا الإعلامي المغربي نزار الفراوي على أجنحة كتابه “فاس.. ذاكرة الروح وأنفاس المكان”، الصادر حديثا عن دار النشر “سليكي أخوين”، إلى أمكنة وأزمنة مدينة ضاربة في العراقة، في سعي للقبض على أسرارها الخبيئة، وإحياء ذاكرتها المتوهجة، وترميم رمزي لروحها، واستعادة وهجها الحضاري.
“كتابة المدن”: رهان استعادة روح المكان
يستعيد نزار الفراوي، عبر جولة في فضاءات مختلفة “رفقة جماليات الأمكنة، وعبقرية الأعلام وديمومة الآثار، في رحلات ذهاب وإياب بين ماضي وحاضر” هذه المدينة (ص 12)، أبعاد ومكونات رمزيتها الحضارية والتاريخية، محتفيا بآثار “الملل والنحل التي تلاقحت فيها أسفار الغريب الوافد مع تمائم الأهالي وخبرات معيشهم”، حيث “نسي الأندلسي أنه أتى، وغفل القيرواني عن طريق القافلة وكذلك تعمد النازلون من الأحواز في الغزوات بماء الساقية فلانت رماحهم في تجربة التمسح بمزار مولاي إدريس. تفضح الأسماء غربة الفاسيين بعد كل قرون التوطن، لكنها غربة تمخضت هوية” (ص 13).
ولأن رهاناته أكبر وأعمق من انجذاب سياحي أو عرض ترويجي أو استرجاع زمني باهت، أو تأريخ كرونولوجي بارد ليوميات مدينة الأسرار، يطمح الكاتب، متسلحا “على خطى الصحافي بعين يقظة، لمعانقة المكان باستنفار في الحواس وتواصل فعال مع الآثار المحفوظة والشخصيات العابرة” (ص 12)، إلى “تدارك الفراغ الهائل في كتابة المدن، والاحتفاء بالمكان، سواء من خلال قيمته الخاصة وجمالياته، أو من خلال علاقة الذاكرة الشخصية به”، بهدف “حفظ أثر الزمن في الحياة والناس. لأننا حين ننساه ينسانا، فننسى أنفسنا” (ص 121).
بتأمل هادئ، وإنصات عميق لتجليات وإيقاع الحياة في هذه المدينة المتمنعة، “التي أبعد من أن يلم بها كتاب”، يقتفي الصحافي الحاصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط تجليات حضورها المادي واللامادي، وظلال المتخيلات واليوتبيات التي شيدت صورتها ورمزيتها، وخلدت أثرها في الزمن والتاريخ والذاكرة والوجدان والقلب والفن والإبداع والعمران..، معيدا تركيب أجزاء من تاريخ حاضرة، تلاقحت أمشاجها المغربية والمشرقية والأندلسية لتشكل تجربة حضارية متفردة، ونموذجا كونيا للعبقرية والتعايش الإنساني.
فاس: كنور مادية ولا مادية.. ترحال في الزمن والذاكرة
يقف الإعلامي الفراوي على “أمكنة تنبض بأسماء من عبروا من أعلام خالدين، مستطلعا وجوه فاعلين معاصرين ترتسم من خلالهم أحوال المشهد الثقافي والفني في عاصمة الروح، مقتفيا أثر فاس في النص الإبداعي، شعرا ورواية، ولوحة، مستعيدا نوستالجيا الفضاء الجامعي ظهر المهراز، حاضن النخب الفكرية والسياسية” (ص 12)، ليقترح تاريخا وجدانيا وروحيا جديدا لهذه المدينة، يرصد من خلاله عوالم ومعالم وقضايا تتصل بالواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي في مغرب المرابطين أو الموحدين أو المرينيين أو التاريخ المعاصر، بأفق منفتح على المستقبل.
يحتفي الكاتب، من خلال أمكنة خالدة، (من الصفحة 32 إلى الصفحة 50) بأربعة أيقونات رفيعة المقام، مرموقة الدرجات في السلم والصرح الفكري والحضاري العالمي، كان لفاس المرابطين والموحدين والمرينيين الفضل عليهم، وشرف إيوائهم وتوفير الشروط والمقومات المناسبة لبلورة مشاريعهم الفكرية والفلسفية والثقافية، والمشاركة في تخصيب الفكر والحضارة الإنسانية، من خلال الأثر الكبير الذي خلفوه، والمساهمة النوعية التي قدموها من أجل إشعاع المغرب والأندلس، وإرساء مقدمات النهضة الأوروبية الحديثة، ويتعلق الأمر بكل من ابن خلدون، ولسان الدين بن الخطيب، وليون الإفريقي (الحسن الوزان الفاسي)، وابن عربي.
في هذا السياق، يسلط الكاتب الضوء على مسارات هذه القامات الأربع التي كان لها الأثر العظيم في تشكيل وبلورة الصرح العقلاني والعرفاني للفكر العربي الإسلامي، من خلال رصد محطات من حيواتهم وإقامتهم الباذخة بهذه المدينة، التي ستصبح وجهة المضطهدين النازحين من الأندلس بعد سقوط غرناطة آخر معقل للعرب بشبه الجزيرة الإيبرية.
فاس كما لم تشاهدوها من قبل، هي تلك المدينة/ الحلم التي يقترح الفراوي علينا، عبر استنفار حواسه وإحساساته ورؤيته الكوسمبوليتية وسرديته المتأججة بفيوض المعنى، أن نقتفي جماليات أثرها وأزمنتها وأعلامها المرموقين، في مشاهد وصفية غير مسبوقة ولا مطروقة، تجول بنا أحياء ودروب وأزقة المدينة العتيقة (باب عجيسة، بوجلود، الطالعة الصغرى، الطالعة الكبرى، ضريح مولاي إدريس، جامع القرويين، الرصيف، باب محروق، جنان السبيل، مقهى الناعورة، ثانوية مولاي إدريس، دار ادبيبغ…)، حيث تتعايش آثار الدول والسلالات وتتواشج الأزمنة التاريخية واللحظات الطللية المجللة بسحر الفن “في متاهة تكفل للأمكنة غموضها وأسرارها المقدسة” (ص 13).
مشاهد رحلات روحية تنطلق بنا من بيت ابن خلدون بدرب “سيدي الدراس”، المتفرع عن الطالعة الكبيرة، “الحي المفضل لسكن وجهاء ونخب القصر المريني، في بيت آوى ابن خلدون زمنا مديدا، وعاش مخاض تأملاته الخالدة في قوانين الاجتماع وسنن التاريخ وأحوال العمران”. ولكم أن تتخيلوا “الرجل منزويا في ركن يحرر مخطوطات من “العبر”، يتمشى في الفناء المفتوح مشتبكا مع فكرة متمنعة أو مفهوم ملتبس، يتوضأ بماء السقاية التي تشكل عصب نظام الماء في البيوت الفاسية التقليدية حتى اليوم، يخرج منحدرا عبر الأزقة وصولا إلى القرويين، لموعد درس أو للقاء شيخ، هو الذي أقر بفائدة عظيمة تأتت له من رحلته التي طالما تطلع إليها نحو عاصمة الغرب الإسلامي، مركز حج العلماء من الأندلس والقيروان وباقي مدن المغرب” (ص 13).
في نفس هذه الرحلة الماتعة، ينقلنا هذا الإعلامي الباحث في العلاقات الدولية، الذي اكتوى بعشق فاس متأخرا بعدما عاش فيها، للمفارقة، “زمنا طويلا في وضع صدامي”، إلى “باب المحروق” حيث “يطل الدفين (لسان الدين ابن الخطيب) على ساحة مأساته بأنين أزلي يسلو عنه بروح مجنحة يطيب مقامها خلود الأثر وتناسخ التجربة عبر العصور والأمصار. أمتار تفصل القبر ومسرح الجريمة، القتل الثاني. تذكروه في ليلة ظلماء فشيدوا له ضريحا مجللا بقرميد أخضر. وحفظ الباب رماد جثمانه واسما قرينا للطقس الجنوني الذي تكلل بتفحيم الجثمان توخيا لأذى موغل يتلف الكيان ويبدد حظوظ خلود رمزي” (ص 32).
ويعرج بنا بعد ذلك إلى فاس الموحدية “التي ترفع علم القيادة في غرب المتوسط، في زمن احتدام الصراع حول السيادة العربية الإسلامية في العالم الإيبيري، حيث يهب سلاطين المغرب في جولات كر وفر، منعا للقشتاليين من تحقيق حلم الاسترداد على حساب ممالك متذبذبة القوة والمراس، التي يقصدها الشيخ الأكبر ابن عربي” (ص 42)، محققا في مقامه هناك “محطات حاسمة من مغامرته الروحية مما يجعل المدينة محطة تحضير لبلورة تأملاته في “الفتوحات المكية”” (ص 46)، مترددا على “مسجد الأزهر”قرب “درب العقيبة” غير بعيد عن ساحة “باب عجيسة”، حيث حقق هناك “منزلة النور” التي انكشفت له من خلالها حقيقة “الإنسان الكامل”. لقد “تبددت الأبعاد الأربعة للفضاء وانفتح له مجال الرؤية منها جميعا، حتى أصبحت كلها وجهة للقبلة” (ص 45).
وهي فاس الحسن الوزان الفاسي/ ليون الإفريقي “ابنها بالتبني، حل بها، ثلاث سنوات بعد سقوط غرناطة، في كنف الأسرة الأندلسية المهاجرة ليصبح سفيرها إلى العالم، عنوان هوية سمتها التعدد والانفتاح (…). وفي قلب المدينة العتيقة، داخل هذا الزقاق المغلق بين سوق العطارين وسوق الحناء، قريبا من قيسارية الأثواب والقرويين، يتوقف الزمن عند محلات بيع المشط التقليدي، والحناء والغسول والأعشاب وأواني الفخار، ووسطه تعلو شجرة معمرة ضخمة الجذع، بينما ترتسم على جدار المبنى القديم من طابقين لوحة تشير إلى مارستان سيدي فرج، الذي بني حوالي 1286 على يد السلطان المريني يوسف بن يعقوب، وبلغ أوج ازدهاره في القرن الرابع عشر. هنا عمل الحسن الوزان ككاتب يوثق مختلف المعاملات، لمدة ناهزت عامين. أول مستشفى للأمراض النفسية في العالم الغربي بمدينة بلنسية الإسبانية عام 1410 (ص 37/38).
أركيولوجية روحية”: تصور جديد لكتابة المدن”
بأفقه الثقافي والفكري المجدد، ورؤيته التاريخية المنفتحة، وكتابته المتحررة من النمطية السردية، يؤسس كتاب “فاس.. ذاكرة الروح وأنفاس المكان” لمتن ثقافي جديد، و”أركيولوجية روحية” تراهن على الفن وسحر الكتابة للقبض على زمن ضائع منفلت، عصي على التأريخ، غير ذاك الذي تكلمت عنه كتب التاريخ أو الذي تحاول عمليات الترميم أن تحييه… بل هو ذلك الضوء الهارب، “ذاكرة الروح وأنفاس المكان”… الكتاب الروحي/ المتعدد الآفاق والعوالم والمتحرر من سلطة التجنيس والتنميط، الذي جعل الناقد فريد الزاهي لا يتردد في الإقرار، في تقديمه لهذا الإصدار الجميل،بأن الإعلامي الفراوي بهذه التحفة الإبداعية الباذخة “يؤسس لكتابة جديدة متحررة من الأنواع الأدبية، منصتة لإيقاعات الذات والمدينة، تمتزج فيها الشهادة بالحب، بالاستقصاء والبحث، لتقدم لنا رؤية منظورية تُعْدينا بنفحتها، وتترك في عيون ذاكرتنا نكهة الاستكشاف المتجدد” (ص 9).

متعة السرد: رهان لمواجهة المحو والهجوم الضاري على الذاكرة
عبر رحلة حج شخصي، متجولاً بين الذات والزمن، وبلغة عاشقة وكتابة سردية تنهض على رؤية ومقومات فكرية، عصارة انصهار معارف وثقافات وتجارب وجودية شخصية متعددة، وبلذة امتلاك روح هذه المدينة، وكشف مباهجها ونفائسها المرئية واللامرئية، يضفي الكاتب حياة متجددة على حاضرة متحولة، من خلال كتابة تتضوع منها روائح ونوستالجيا تحيل على الذاكرة والأزمنة الثقافية والحضارية والاجتماعية التي تشكلت في بوتقتها فاس.
يقوم الكاتب بسفرين، أحدهما ذهابا وإيابا بين الماضي والحاضر، بـ”تجربة شخصية مباشرة، أشبه بطقس حج روحي”، والآخر نحو التخوم البعيدة للمعنى المغمس ببهجة السرد، المنغمس في موضوعه، والمتوحد مع أمشاج وروح الأمكنة لدرجة يصير فيها هذا السرد جزءا من هذه الأخيرة، يجلي جمالياتها ونفائسها وذخائرها وعجائبها وغرائبها وحكاياتها وحياة الناس فيها، ويتجلى، في آن واحد، رائقا ساحرا كأنه روح المدينة وعطرها وقد عادت إلينا حلما وحقيقة…، في رهان على جماليات الكتابة وقدرتها على التعويض ومقاومة أشكال المحو والمسخ التي تتعرض لها الذاكرة، واستعادة روح وريثة الأندلس، فاس التي من “منة الجغرافيا ورحمة التاريخ أن ظلت حدودها العتيقة مرسمة بلا امتداد عمراني طارئ يبطل الفرادة ويوجع الموتى ويلف المكان في الهجانة القاتلة لتمدن يمتص روح الامنكنة” (ص 13).
فاس الأندلسية: رهانات معاصرة ودروس وعبر
نفتح كتاب نزار الفراوي على المستقبل، فرحلته عبر التاريخ الوسيط والمعاصر لاستعادة عبق فاس كما كانت عاصمة الجمال والفن والفكر، لا تستكين إلى نوستالجيا مزمنة، بل تحيل على “حالة حضارية خالدة”، يستعيد من خلالها ألق الروح الكونية لـ”فاس التي كانت”، تلك الملحمة الإنسانية والأيقونة الحضارية التي انصهرت فيها العبقرية والإبداع البشري الخلاق، وتلاقحت في رحابها الديانات والثقافات والأفكار، مسرح الأحداث والوقائع التاريخية الفارقة، وأرض التلاقح والحوار.
بكل هذه الهواجس يستدعي الكتاب ذلك المشترك الحضاري بين فاس والأندلس، عبر استحضار مناحٍ من الحياة الفكرية والفنية والعلمية التي ميزتهما خلال محطات من تاريخهما المشترك، ومظاهر التثاقف بينهما، والذي تجسد في إبداعات فكرية وشعرية وفلسفية وتقاليد العيش المشترك والموسيقى الأندلسية وطرب الملحون، حيث “تتراقص النغمة الأندلسية في فضاءاتها ويوميات أهلها، بخيلاء ونشوة وإغواء، تمارس نزهتها اليومية بين ورشات الصناع وأفنية البيوت وأثير الإذاعة المحلية وحجرات المعهد الموسيقي وفي البساطات الخضراء لربيع يشب بعنفوان في أحواز المدينة مجللا طقوس “النزاهة”. ليس ذلك فقط، بل شقت الموسيقى الأندلسية طريقا لها إلى الاحتفاليات الاجتماعية والعائلية، لتستوطن المجال كعنصر مكين يؤثث المشهد في أفراح فاس وأعيادها. الموسيقى الأندلسية، أو موسيقى الآلة، ديوان أشعار وموشحات وأزجال، تركة ساهم فيها شعراء من عصور مختلفة، صبوا قريحتهم في أغراض متنوعة مدحا وغزلا وتصوفا..” (ص 24).
بهذه الروح، يدعو نزار، المقيم بسويسرا “مراسلا فوق العادة” لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى استلهام روح فاس الأندلسية، والانفتاح على منجمها الحضاري ومنظومة قيمها الإنسانية، باعتبارها نقطة التقاء حضاري وفكري وإنساني متفرد، والوجه المشرق للثقافة الأندلسية، والحاضنة للقيم الكونية التي خلفتها هذه الحضارة وطورتها بفضل إسهامات كبار العلماء والمتصوفة والشعراء والمنشدين، بعد أن “تفرقت الأندلس إرثا لأحفاد الفردوس، أصبح ملكا في ذمة الإنسانية وعنصرا مخصبا للحضارة العربية والمتوسطية. تلاقح الرصيد الوافد في موجات النزوح القسري مع المقومات الثقافية في أماكن الاستقبال، لكن فاس استجمعت من العوامل الحاضنة مع أهلها لتكون وريثا متصدرا لأشياء كانت مرشحة للاندثار، فدامت وتجذرت في تربتها وانصهرت في هويتها المتعددة، محدقة في وجه المستقبل بيقين الخلود” (ص 24).
يراهن هذا التكثيف العشقي لفاس، والاستحضار القوي لأزمنتها التاريخية، الأندلسية منها على الخصوص، عـلى الكتابة والفن كتعويض عن فقدان فاس، التي شكلت حالة سعادة عمرانية وفكرية وجمالية… لينتخبها قدرها لاستيعاب وصون روح الأندلس التي “تفرقت بين القبائل غرب المتوسط، وشرقه، بل أبعد. حمل المهجرون ما قل من متاعهم، وكل ذاكرتهم. مر الزمن الأول بوهم عودة محتومة على متن المراكب الرابضة في السواحل. وكلما توطن التسليم باستحالة العودة، شحذ الأندلسي أجهزة التعويض النفسي عن حقيقة الفقدان، وانبرى يحرث، بدلا عن الرقعة المسلوبة، أرضا لا ينازعه فيها أحد، ذاكرة جريحة تترنح شعرا ولحنا” (ص 24).
إن استعادة روح زمن فاس الفكري والحضاري الأندلسي يمر، كما يحرض ضمنيا على ذلك الإعلامي الفراوي، عبر الثقافة والمعرفة كأولويات للتنمية والنهضة المجتمعية، من منطلق كون حالة التلاقح المغربي الأندلسي، التي يسافر بنا إلي أزمنتها الفاسية، تشكل فرادة ذلك النموذج الحضاري في عصره ومحيطه، والذي لا يزال قادرا على مدنا اليوم بعناصر ومقومات قوة رمزية موحية يمكن أن توجه سياساتنا، وتجدد مشتركنا الإنساني، من خلال العودة إلى الأصول والمنطلقات المؤسسة، بغية النهل منها واستلهامها في أفق صياغة معالم نموذج حضاري بديل.
ينقلنا كتاب الفراوي لنعيش فاس من جديد، ونتذوق الحياة والسعادة والبهجة وحلاوة المجد التاريخي المغربي، ونعيد اكتشاف دروبها وأزقتها، وقصة الإبداع الإنساني فيها، وديمومة الأثر والزمن، وإيقاع الحياة الفكرية والثقافية باعتبارها حركية وتقدما وازدهارا مجتمعيا كان فيه للفكر والفلسفة والعقل والروح الأثر الكبير في تشييد حضارة خالدة، وقبل كل ذلك يفرد لنا شباك غوايته وشراك غابته السردية الساحرة وجلال وجمال كتابته الآسرةليوقع بنا في حالة سكر جمالي وإمتاع طافح بأنوار وأسرار هذه الحاضرة المنفلتة المتمنعة التي تتركنا، رغم كرمها الحاتمي، “ندور وندور بإحساس حتمي بالنقصان والضآلة أمام زخم المكان وامتداده المضاعف في طيات الزمن وتعددية العناصر وأبدية الفضاء في مواجهة الإهمال والهجوم الضاري على الذاكرة”.
(ولنا عودة للموضوع)
[ad_2]